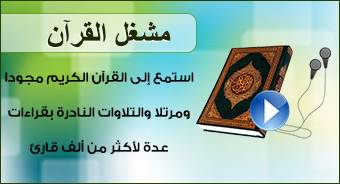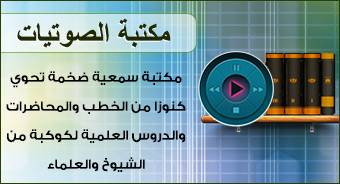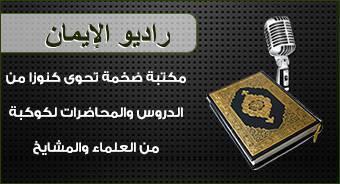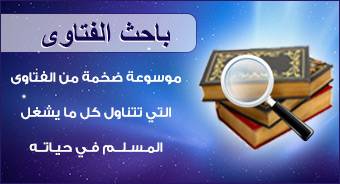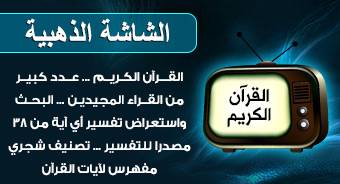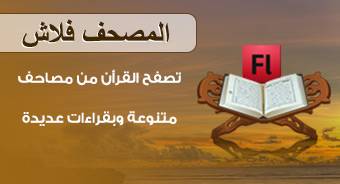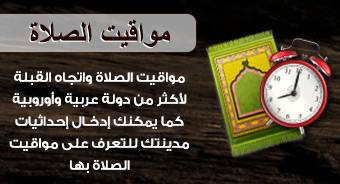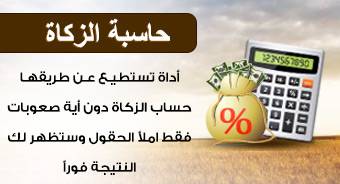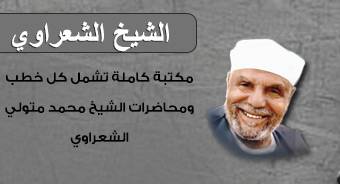|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
إن التقية رخصة من الله، روى: أن مسيلمة الكذاب جاء برجلين من المسلمين وقال لواحد منهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال المؤمن نعم: قال مسيلمة: وتشهد أني رسول الله؟ قال المؤمن: نعم. وأحضر مسيلمة المسلم الآخر وقال له: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال المؤمن: نعم. قال مسيلمة: أتشهد أني رسول الله؟ قال المؤمن الثاني: إني أصم كيف رد عليه المؤمن بدعوى الصمم؟ لقد علم مسيلمة أنه يدعي الصمم، لذلك أخذه وقتله، فرفع الأمر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: «أما المقتول فقد صدع بالحق فهنيئا له، وأما الآخر فقد أخذ برخصة الله». فالتقية رخصة، والإفصاح بالحق فضيلة.وعمار بن ياسر أخذ بالرخصة وبلال بن رباح تمسك بالقرعة.ولننظر إلى حكمة التشريع في هذا الأمر. إن كل مبدأ من مبادئ الخير جاء ليواجه ظاهرة من ظواهر الشر في الوجود، وهذا المبدأ يحتاج إلى منهج يأتي من حكيم أعلى منه، ويريد صلابة يقين، وقوة عزيمة، كما يريد تحمل منهج، فالتحمل إنما يكون من أجل أن يبقى المنهج للناس، والعزيمة من أجل أن يواجه المؤمن الخصوم، فلو لم يشرع الله التقية بقوله: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمان} [النحل: 106].لكنا حقيقة سنحقق الفدائية التي تفدي مناهج الحق بالتضحية بالحياة رخيصة في سبيل الله، ولكن هب ان كل مؤمن وقف هذا الموقف فمن يحمل علم الله إلى الآخرين؟ لذلك يشرع الحق سبحانه وتعالى التقية من أجل أن يبقى من يحمل المنهج، أنه يقرر لنا الفداء للعقيدة، ويشرع لنا التقية من أجل بقاء العقيدة. لقد جاء الحق بالأمرين: أمر الوقوف في وجه الباطل بالاستشهاد في سبيل الحق، وأمر التقية حماية لبعض الخلق حتى لا يضيع المنهج الحق لو جاء جبار، واستأصل المؤمنين جميعا، لذلك يشرع الحق ما يبقى للفداء قوما، ويبقى للبقاء قوما ليحملوا منهج الله، هل عرفنا الآن لماذا جاءت التقية؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد منهجا يعمر الأرض، ويورث للأجيال المتتالية، فلو أن الحق لم يشرع التقية بقوله: {مَن كَفَرَ بِالله مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمان وَلَاكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106].لثبتت الفدائية في العقيدة، ولو ثبتت الفدائية وحدها لكان أمر المنهج عرضه لأن يزول، ولا يرثه قوم آخرون، لذلك شرع الله التقية ليظل أناس حول شمعة الإيمان، يحتفظون بضوئها؛ لعل واحدا يأخذ بقبسها، فيضيء بها نورا وهاجا. ولذلك، فلا ولاية من مؤمن لقوم كافرين إلا أن يتقى منهم تقاة، لماذا؟ لأن الله يحذرنا نفسه بقوله: {وَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ}.فإياك أن تقبل على السلوك الذي يضعه أمامك الكفار بانشراح صدر وتقول: أنا أقوم بالتقية، بل لابد أن تكون المسألة واضحة في نفسك، وأن تعرف لماذا فعلت التقية، هل فعلتها لتبقى منهج الخير في الوجود، أو لغير ذلك؟ هل فعلتها حتى لا تجعل جنود الخير كلهم إلى فناء أو غير ذلك؟ أنك إن فعلت التقية بوعي واستبقيت نفسك لمهمة استبقاء المنهج الإيماني، فأنت أهل الإيمان، وعليك أن تعرف جيدا أن الحق قد قال: {وَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ}. أنه الحق يقول للمؤمنين: إياكم أن تخلعوا على التقية أمرا هو مرغوب لنفوسكم، لماذا؟ لأن الحق قد حددها: {مَن كَفَرَ بِالله مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمان وَلَاكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106].فلا غاية إلا الله، فإياكم أن تغشوا أنفسكم؛ لأنه لا غاية عند غيره؛ فالغاية كلها عنده وبعد ذلك يقول الحق: {قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله}. اهـ.
أفاده الزمخشري {إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً} أي: تخافوا منهم محذورًا. فأظهروا معهم الموالاة باللسان دون القلب لدفعه، كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وأصل: تقاة وقية، ثم أبدلت الواو تاء، كتخمة وتهمة، وقلبت الياء ألفًا. وفي المحكم: تقاة: يجوز أن يكون مصدرًا وأن يكون جمعًا، والمصدر أجود، لأن في القراءة الأخرى: تقية.تنبيه:قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة الآية الكريمة تحريم موالاة الكفار، لأن الله تعالى نهى عنها بقوله: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَيْءٍ}، ثم استثنى تعالى التقية فرخص في موالاتهم لأجلها، فتجوز معاشرة ظاهرة، والقلب مطمئن بالعداوة لهم والبغضاء وانتظار زوال المانع.وقد قال الحاكم: في الآية دلالة على جواز إظهار تعظيم الظلمة اتقاء لشرهم. قال: وإنما يحسن بالمعاريض التي ليست بكذب، وقال الصادق: التقية واجبة، وإني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فأستتر عنه بالسارية لئلا يراني.وعن الحسن: تقية باللسان، والقلب مطمئن بالإيمان.واعلم أن الموالاة، التي هي المباطنة والمشاورة وإفضاء الأسرار للكفار، لا تجوز. فإن قيل: قد جوز كثير من العلماء نكاح الكافرة، وفي ذلك من الخلطة والمباطنة بالمرأة ما ليس بخاف، فجواب ذلك: أن المراد موالاتهم في أمر الدين، وفيما فيه تعظيم لهم. فإن قيل. في سبب نزول الآية أنه صلى الله عليه وسلم منع عُبَاْدَة بن الصامت عن الاستعانة باليهود على قريش! وقد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود على حرب قريش، وفي هذا دلالة على جواز الاستعانة بهم. وقد ذكر الراضي بالله أنه يجوز الاستعانة بالفساق على حرب المبطلين. قال: وقد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود على حرب قريش وغيرها، إلى أن نقضوه يوم الأحزاب. وحدَّ صلى الله عليه وسلم الحلف بينه وبين خزاعة. قال الراضي بالله: وهو ظاهر عن آبائنا عليهم السلام، وقد استعان علي عليه السلام بقتلة عثمان. ولعل الجواب- والله اعلم- أن الاستعانة جائزة مع الحاجة إليها. ويحمل على هذا استعانة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود. وممنوعة مع عدم الحاجة، أو خشية مضرة منهم. وعليه يحمل حديث عُبَاْدَة بن الصامت. فصارت الموالاة المحظورة تكون بالمعاداة بالقلب للمؤمنين، والمودة للكفار على كفرهم، ولا لبس في تحريم ذلك، ولا يدخله استثناء والموالاة بإظهار التعظيم وحسن المخاللة والمصادقة بإظهار الأسرار ونحو ذلك، فلا لبس في تحريم ذلك ولا يدخله استثناء، والموالاة بإظهار التعظيم وحسن المخاللة والمشاورة فيما لا يضر المسلمين، فظاهر كلام الزمخشري أنه لا يجوز إلا للتقية. فحصل من هذا أن الموالي للكافر والفاسق عاصٍ، ولكن أين تبلغ معصيته؟ يحتاج إلى تفصيل: إن كانت الموالاة بمعنى الموادة، وهي أن يوده لمعصيته كان ذلك كالرضا بالمعصية. وإن كانت الموالاة كفرًا، كفر. وإن كانت فسقًا، فسق. وإن كانت لا توجب كفرًا ولا فسقًا، لم يكفر ولم يفسق، وإن كانت المولاة بمعنى المحالفة والمناصرة، فإن كانت محالفة على أمر مباح أو واجب، كأن يدفع المؤمنون عن أهل الذمة من يتعرض لهم، ويخالفونهم على ذلك، فهذا لا حرج فيه، بل هو واجب. وإن كانت على أمر محظور كأن يحالفوهم على أخذ أموال المسلمين والتحكم عليهم، فهذه معصية بلا إشكال، وكذلك إذا كانت بمعنى أنه يظهر سر المسلمين ويحبّ سلامة الكافرين لا لكفرهم، بل ليدٍ لهم عليه أو لقرابة أو نحو ذلك، فهذا معصية بلا إشكال. لكن لا تبلغ حدها الكفر، لأنه لم يُروَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بكفر حاطب بن أبي بلتعة.وقال الراضي بالله: إن مناصرة الكفار على المسلمين توجب الكفر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للعباس: «ظاهرك علينا». وقد اعتذر بأنه خرج مكرهًا. وأما مجرد الإحسان إلى الكافر فجائز لا ليستعين به على المسلمين، ولا لإيناسه. وكذلك أن يضيق لضيقه في قضية معينة لأمر مباح فجائز، كما كان من ضيق المسلمين من غلب فارس الروم، فصار تحقيق المذهب أن الذي يوجب الكفر من الموالاة أن يحصل من الموالي الرضا بالكفر. والذي يوجب الفسق أن يحصل الرضا بالفسق. إن قيل: فما حكم من يجند مع الظلمة ليستعينوا به على الجبايات وأنواع الظلم؟ قلنا: عاص بلا إشكال، وفاسق بلا إشكال، لأنه صار من جملتهم. وفسقهم معلوم. فإن قيل: فإن تجند معهم لحرب إمام المسلمين؟ قلنا: صار باغيًا، وحصل فسقه من جهة البغي والظلم. فإن قيل: حكي عن المهدي علي بن محمد عليه السلام أنه كفّر من تجند مع سلطان اليمن وقضى بردته، قلنا: هذا يحتاج إلى بيان وجه التكفير بدليل قطعي. وإن ساغ أن نقول ذلك اصطلاح لأمر الإمام كما رد الهادي عليه السلام شهادة من امتنع من بيعة الإمام كان ذلك محتملًا- انتهى كلامه رحمه الله.ومن هذه الآية استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف. وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابه: إيثار الحق على الخلق فقال ما نصه:وزاد الحق غموضًا وخفاءً أمران:أحدهما: خوف العارفين، مع قلتهم، من علماء السوء وسلاطين الجور، وشياطين الخلق، مع جواز التقية عند ذلك بنص القرآن وإجماع أهل الإسلام. وما زال الخوف مانعًا من إظهار الحق، ولا برح المحق عدوًّا لأكثر الخلق. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في ذلك العصر الأول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما: فبثثته في الناس، وأما الآخر: فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وما زال الأمر في ذلك يتفاحش. وقد صرح الغزالي بذلك في خطبة المقصد الأسنى ولوّح بمخالفته أصحابه فيها كما صرح بذلك في شرح الرحمن الرحيم فأثبت حكمة الله ورحمته، وجود الكلام في ذلك، وظن أنهم لا يفهمون المخالفة، لأن شرح هذين الاسمين ليس هو موضع هذه المسألة، ولذلك طوى ذلك، وأضرب عنه في موضعه، وهو اسم الضار كما يعرف ذلك أذكياء النظار.وأشار إلى التقية الجويني في مقدمات البرهان في مسألة قدم القرآن. والرازي في كتابه المسمى بالأربعين في أصول الدين إلى آخر ما ساقه المرتضي فانظره.{وَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ} أي: ذاته المقدسة، فلا تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه، وموالاة أعدائه. وهو تهديد عظيم مشعر بتناهي المنهي في القبح، وذكر النفس، ليعلم أن المحذر منه عقاب يصدر منه تعالى، فلا يؤبه دونه بما يحذر من الكفرة: {وَإِلَى الله الْمَصِيرُ} أي: المنقلب والمرجع ليجازي كل عامل بعمله. اهـ.
|